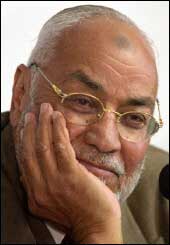أعرف مسبقا أنه ربما تكون فكرة سخيفة أن استعرض سريعا ما كتبته في مدونتي منذ أن بدأت الكتابة بها شهر يوليو الماضي وحتى الآن، فأنا لست في برنامج تليفزيوني مثلا استعرض لكم "حصااااد العام"، لكني أبدو مشدودة للفكرة بقوة غامضة كتلك التي تتلبسني حين تجيء لي فكرة قصة أو مقال، فمعلش بقى!
فالحقيقة أن مدونتي المتواضعة (واتكلم براحتك!) قد أسهمت بتدوين بعض الأحداث الهامة في حياتي الشخصية بل وتجاوزت ذلك بكثيير، فكانت هي مثلا الشيئ الذي ُيدخل على أخي مسحة من البهجة وهو في مستشفى عين شمس، ولا زلت أتذكر أخي وهو يضحك و أنا أقرأ له "سبعة أيام بين باربي وكين" ، كنت ما أكتبه وقتها حالة من فك الحصار على أخي التي كانت المحاليل وخراطيم العلاج تخترق جسده وروحه معا! حتى عندما خرج أخي من المستشفى، كنت أهديه تحفة أخرى "تمثال رمسيس قشطة عليه!" ؛ ليس من عادتي استخدام كلمات مثل "قشطة" و"صباحين وحتة!" لكن يبدو أن هذه الأشياء كانت حالة تعويضية لمشاعر الحزن التي كنت أعيشها بسبب مرض أخي، وبالمناسبة فقد يفسر ذلك لماذا يحب المصريون الهزار والنكت والمصطلحات الإفتكاسية، لأن تلك الأشياء وحدها هي المعين الأول- بعد الله سبحانه وتعالى- على الظلم والقهر وقلة الحيلة، وألا أنتم لكم رأي تاني؟!
وعلى الصعيد السياسي (جامدة الجملة مش كدة!) ، فقد ساعدتني المدونة على فك طلاسم عقدة قديمة عندي تجاة الأخوان ، ففي مقال "السم ولا الحبل؟" كنت بصراحة أعلن عدم ارتياحي للأخوان (السم) و اتحير من جمال مبارك (الحبل) ، والآن أعلن بجد وأنا مرتاحة الضمير أن السم أفضل بكثييييير من الحبل وأنه لو وقعت مصر في براثن الأخوان فإن ذلك سيكون أشرف لها من أن تقع في براثن من يعذبها ويهينها كل يوم! وإن كنت حتى لا أرى أن هذا الإحتمال سيتحقق!
وإذا ذهبنا إلى عالم الثقافة والجو ده، فإن هناك أشياء حدثت في عام 2006 أعتز بها ، مثل مقابلتي للأستاذ جمال البنا (العالم الجليل بالرغم من تصريحاته المدوية والمثيرة للجدل) مثل لقائي مع د.علاء الأسواني الذي يؤمن بي و يعطيني الأمل في الغد ، مثل احتفاء ندوة جلسة ثقافية "بالبلياتشو" ، مثل نجاح فرقة "جميزة" في الساقية، مثل إكتشافي البارحة أن خمس نسخ من البلياتشو قد تم بيعها من مكتبة ديوان! يا رب يا كريم!
بقى أن أقول أمنياتي للعام القادم، أن يكون أخي بخير، أن تتحقق دعوات والدتي لي كلها! وألا أغلق المدونة مهما حدث! فقد أصبحت بالنسبة لي أشبه بقارب صغير أحب أن أكون بداخله، أترك المجداف كي يسير كما يريد، أغلق عيني حين يزداد اتساع الأفق، وأحلم.
--------------------------------
"أبقوا معنا" بقى ! فمع "دردشة "............. مش حتقدر تبطل كلاااااام!
كل سنة وأنتم طيبيين ....
فالحقيقة أن مدونتي المتواضعة (واتكلم براحتك!) قد أسهمت بتدوين بعض الأحداث الهامة في حياتي الشخصية بل وتجاوزت ذلك بكثيير، فكانت هي مثلا الشيئ الذي ُيدخل على أخي مسحة من البهجة وهو في مستشفى عين شمس، ولا زلت أتذكر أخي وهو يضحك و أنا أقرأ له "سبعة أيام بين باربي وكين" ، كنت ما أكتبه وقتها حالة من فك الحصار على أخي التي كانت المحاليل وخراطيم العلاج تخترق جسده وروحه معا! حتى عندما خرج أخي من المستشفى، كنت أهديه تحفة أخرى "تمثال رمسيس قشطة عليه!" ؛ ليس من عادتي استخدام كلمات مثل "قشطة" و"صباحين وحتة!" لكن يبدو أن هذه الأشياء كانت حالة تعويضية لمشاعر الحزن التي كنت أعيشها بسبب مرض أخي، وبالمناسبة فقد يفسر ذلك لماذا يحب المصريون الهزار والنكت والمصطلحات الإفتكاسية، لأن تلك الأشياء وحدها هي المعين الأول- بعد الله سبحانه وتعالى- على الظلم والقهر وقلة الحيلة، وألا أنتم لكم رأي تاني؟!
وعلى الصعيد السياسي (جامدة الجملة مش كدة!) ، فقد ساعدتني المدونة على فك طلاسم عقدة قديمة عندي تجاة الأخوان ، ففي مقال "السم ولا الحبل؟" كنت بصراحة أعلن عدم ارتياحي للأخوان (السم) و اتحير من جمال مبارك (الحبل) ، والآن أعلن بجد وأنا مرتاحة الضمير أن السم أفضل بكثييييير من الحبل وأنه لو وقعت مصر في براثن الأخوان فإن ذلك سيكون أشرف لها من أن تقع في براثن من يعذبها ويهينها كل يوم! وإن كنت حتى لا أرى أن هذا الإحتمال سيتحقق!
وإذا ذهبنا إلى عالم الثقافة والجو ده، فإن هناك أشياء حدثت في عام 2006 أعتز بها ، مثل مقابلتي للأستاذ جمال البنا (العالم الجليل بالرغم من تصريحاته المدوية والمثيرة للجدل) مثل لقائي مع د.علاء الأسواني الذي يؤمن بي و يعطيني الأمل في الغد ، مثل احتفاء ندوة جلسة ثقافية "بالبلياتشو" ، مثل نجاح فرقة "جميزة" في الساقية، مثل إكتشافي البارحة أن خمس نسخ من البلياتشو قد تم بيعها من مكتبة ديوان! يا رب يا كريم!
بقى أن أقول أمنياتي للعام القادم، أن يكون أخي بخير، أن تتحقق دعوات والدتي لي كلها! وألا أغلق المدونة مهما حدث! فقد أصبحت بالنسبة لي أشبه بقارب صغير أحب أن أكون بداخله، أترك المجداف كي يسير كما يريد، أغلق عيني حين يزداد اتساع الأفق، وأحلم.
--------------------------------
"أبقوا معنا" بقى ! فمع "دردشة "............. مش حتقدر تبطل كلاااااام!
كل سنة وأنتم طيبيين ....